المواضيع الأكثر قراءة
- "فنزويلا بعد مادورو".. سؤال السلطة ومصير الدولة
- مواجهات في الخليل واعتداءات للمستوطنين في سلفيت ورام الله
- نهج تشاركي لحماية الأسرة وتعزيز رفاهها
- وزارة الخارجية تؤكد أن جميع الأردنيين المقيمين والموجودين في فنزويلا بخير
- الأردن يرحب بدعوة رئيس المجلس القيادي اليمني لعقد مؤتمر شامل لبحث الحلول العادلة للقضية الجنوبية
- الأمم المتحدة تراجع عودة اللاجئين السوريين من الأردن 13
- تقدم درع الوطن وانسحاب الانتقالي.. ماذا نعرف عن آخر المستجدات في اليمن؟
- كلمة السرّ في الإعجاز القَطَري - | إبراهيم الابراهيم
- أورنج الأردن تطلق "دليل الشمول الرقمي" بلغة برايل لتعزيز تجربة الزبائن من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية
- وفاة رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب
عن كل ما نحتفظ به لننساه!
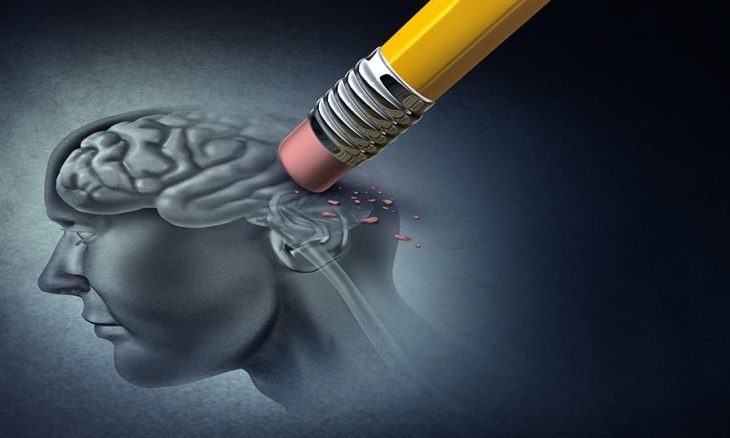
القدس العربي-إبراهيم نصر الله
كنا نكتب رسائل طويلة، بل طويلة جداً أحياناً، يكتبها الآباء لأبنائهم في الغربة، ويكتبها العشاق لمعشوقيهم في الوطن والغربة أيضاً، يكتبها الأصدقاء والأعمام وكل من تربطهم علاقة عميقة قوية بأصدقائهم وأماكنهم الأولى، أماكنهم التي ابتلعها الإسمنت وحوَّلها إلى جدران، أو إلى أولئك الذين سافروا إلى مدن إسمنت جاهزة أعلى وأكبر، وتحولوا إلى جزر معزولة لا تحمل الطائرات إليها، ومنها، سوى ما خف حمله من أحبابهم: شوق أولئك الأحباب في كلمات.
كانت بعض الرسائل تطول بحيث تشكل فصلاً من كتاب، مع أن بيت الحبيب عن الحبيبة قد لا يتجاوز بعده أكثر من مئات الأمتار.
ضمرت الرسائل، بتحوّلات وسائل الاتصال، مثلما تضمر أقدام العاملين على القوارب الصغيرة، بحيث انكمشت وانكمشت إلى أن غدت مجرد برقيات.
لم نحبّ البرقيات يوماً، في الغالب الأعمّ، كانت تحمل إلينا أخباراً سيئة، أو أموراً طارئة، فيرتجف القلب كلما وقف ساعي بريد أمام الباب وهو يناولنا إياها بصمت. هذه البرقيات كانت دائماً مثل المكالمات التي تأتينا بعد منتصف الليل، أو عند الفجر، ونحن نائمون، مُختَصَرة، فلا نسمع في رنين هواتفنا حينها إلا نذر الشؤم.
أتأمل بعض الرسائل القديمة لديّ، مثلما أتأمل أعمالاً فنيّة! فهناك الطابع وعنوان البيت، أو صندوق البريد، واسم المُرسِل، وملمسها. كان الملمس جزءاً منها، وكانت الخطوات القليلة التي نخطوها مبتَعدين عن باب مبنى البريد، أو أقرب شخص موجود بجانبنا، للحصول على مسافة آمنة للانفراد بتلك الكلمات التي قطعت بحاراً وبلاداً شاسعة للوصول، أحياناً، أو قطعت حارات ممتلئة بأعين فضولية وأعين حاسدة وأعين مترقّبة، كان ذلك الابتعاد لا يختلف عن ذلك الحسّ العميق الذي يسكننا ونحن ننفرد بمرسل الرسالة نفسه، حين كان قريباً.
هل كان ذلك الحرص والشغف والانتظار في رسائلنا تعويضاً عن شوقنا لبشر لا نراهم ولا نستطيع لمسهم أو سماعهم؟ هل كان ذلك الفيض العارم من الكلام العذب سبباً أيضاً؟ وهل كان الحنين الجارف هو ما يدفعنا للحرص على أن تتجلى اللغة التي سيقرأها «المفتَقد» على الطرف الثاني من الجدار العالي؟ أم كانت رسائلنا إليه تسعى لبلوغ ما لا نبلغه في حديثنا العادي، لو أتيح لنا الحديث العادي بلا منغصات أو رقباء، أو حتى خجل الذات من بوحها بكل ما فيها؟
هل كان لا بد من الرسائل، تلك الرسائل الورقية، لكي نبوح أكثر وأفضل؟
ربما. حين وصلنا إلى عصر البريد الإلكتروني تغير شيء ما في رسائلنا، أصبحت أقصر، وربما فقدت بعض حرارتها، لكنها ظلت تنتمي لجوهر الرسالة، في مراحلها الأولى على الأقل، حين كان الحصول على الإنترنت مسألة غير متاحة تماماً، لكنها ما إن أصبحت متاحة جداً حتى راحت رسائلنا تضمر إلى أن غدت برقيات، وما إن وصلنا إلى عصر الواتساب وإخوته وأخواته من وسائل الاتصال، حتى ضمرت رسائلنا تماماً، بل أصبحنا نتكاسل في الكتابة، فنعيد إرسال ما يرسله الآخرون إلينا!
لقد ضمرت رسائلنا بحيث لم تعد قادرة على أن توصلنا فعلاً إلى أرواح من نحبهم كما ينبغي أن توصلنا، أو توصلهم. كم تغيَّرنا ونحن نختزل عدد كلماتنا، أو نختزل أنفسنا، أو تختزلنا «طبيعة العصر» حتى ونحن نستخدم كلمة مثل أحبك، أو اشتقت إليك!
.. اليوم تصلك رسائل شبه يومية من أصدقاء مبدعين، كرسائلك التي ترسلها إليهم، ولكنها غير صالحة للنشر، لمحات مستعجلة، أقل أهمية بكثير من همومنا وأسئلتنا!
هل تمنحنا العزلة أرواحاً أكثر صفاء للوصول إلى جوهرنا ونحن نكتب لسوانا، أو نكتب لأنفسنا، أو نكتب، كما لا نكتب حين نكون محاطين بآخرين؟
هل لهذا أصبح محو الرسالة الإلكترونية القصيرة بسهولة، جزءاً من سهولة كتابتها، ولإدراكنا العميق أن ذلك المُرسل على بعد مترين، أو آلاف الكيلومترات قد كتبها بسهولة، بينما هو يتحدث مع شخص آخر، أو يشاهد فيلماً، أو يتناول وجبة، أو حتى أمام إشارة للمرور، بحيث لا نحس بفداحة قيامنا بمحوها؟
هواتف
كان للهواتف دورها، لمن منّتْ عليه الحياة بهاتف، في زمن كان فيه على البشر أن ينتظروا عشر سنوات للحصول على هاتف أرضي، أو يومين لإجراء مكالمة هاتفية مع أحد الأحباب في الخارج. لكن أسعار المكالمات كانت تحول دون استرسالنا، كما أن الحسّ بأن ثمة من يسترق السمع في مؤسسات الاتصالات كان يربط أجزاء تتفاوت قصراً أو طولاً من ألسِنتنا.
لكن ما كان يعوّض عن هذا كله أننا كنا نسمع ذلك الذي نفتقده، أو نشتاق إليه.
ومع انقشاع عصر المكالمات الصوتية المكلفة، وميلاد عصر المكالمات المجانية، المرئية المسموعة، مع أنها ليست مجانية تماماً، هل غدت المكالمات الطويلة بديلاً عن تلك الرسائل المكتوبة بعناية، الحريصة على كل مفردة فيها، وعن نهر الحبر المتدفق بعناية فوق بياض الورق الذي لم يكن غير أنفسنا وأنفاسنا؟
هل استطاع نهر الكلام المتدفق عبر الأمواج والأبراج العالية، أو التقنيات الأكثر سرعة ووضوحاً من كل ما عرفناه من قبل من وسائل اتصال، كافياً لإيصال شوقنا وحنيننا وجوهرنا بالطريقة نفسها، أو أن كلامنا افتقد كثيراً من جوهرنا، حتى في أفضل الحالات التي قد تتجلى فيها بلاغتنا؟
هل باتت المسألة تشبه الفرق بين من يسرد عليك قصة جميلة، ونكتشف فيها شيئاً آخر حين يكتبها، أو يكتبها غيره، لأنه تكثّف في الكتابة أكثر مما يتكثف في القول السهل؟ وهل لأن كل ما لا يكتب لا يعوَّل عليه؟!
صور
هل أصاب الصور ما أصاب الرسائل؟ الصور التي كنا نبذل الكثير من الحرص كي تكون في أفضل صورة! فنلبس أفضل ما لدينا، ونختار خلفية لها، ووضعاً، وضَوءاً مناسباً، وننتظر تظهيرها على أحر من الجمر، وحين نرسلها إلى من نُحبّ ونفتقد، نرسل جزءاً من أنفسنا حقاً، بل أنفسنا؟
اليوم تتلاشى هذه الرسائل والصور لمجرد أننا نغير هواتفنا، دون أن نفكر باستنساخها أحياناً، كما أن كثيراً مما نحتفظ به بتنا نحتفظ بها لننساه.
وبعد: هل بات ذلك كله طبيعياً، لأن البشر باتوا، أصلاً، يتحدثون أقل مع بعضهم بعضاً؟! هل بات ذلك كله شبيهاً بالوردة الحمراء الافتراضية التي باتت تُرسل بسهولة لا تمتّ بصلة للّحظة التي يحمل فيها إنسان وردة حقيقية ويسلمها لمن يحبّ باليد؟


