المواضيع الأكثر قراءة
- رئيس الوزراء يقرر تأخير الدوام إلى العاشرة في الكرك والطفيلة ومعان
- شقيقة رئيس الديوان الملكي الهاشمي في ذمة الله
- الخارجية الأميركية تدعو رعاياها لمغادرة إيران فورًا
- وفد قيادي من حماس يصل القاهرة لبحث استكمال مراحل وقف إطلاق النار
- الأردن: جماعة الإخوان المسلمين منحلة حكما منذ سنوات بقرار قضائي
- "قسد" تستهدف نقاط للجيش السوري ومنازل شرقي حلب
- ضمان التفوق للجيش في الجو والبحر والبر
- على خلفية الاضطرابات في إيران.. مسألة غزة تتأخر
- حين يصبح الفن رسالة سلام وذاكرة وطن وفكر نابض بالروح
- الأردنيون يشيعون رئيس الوزراء الأسبق علي ابوالراغب
أفكار مجنونة
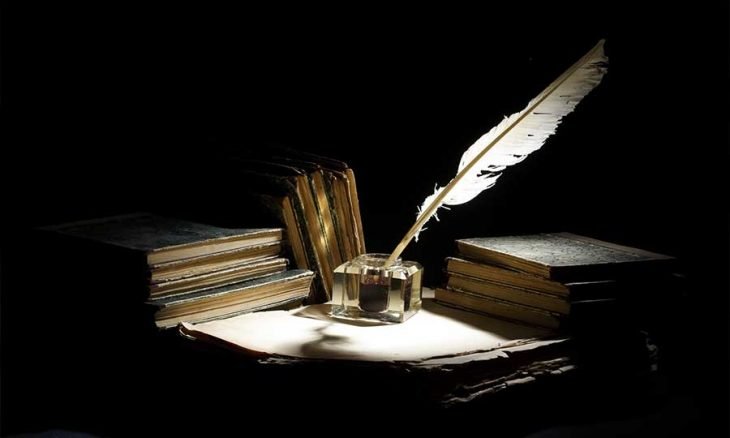
القدس العربي-ابراهيم عبد المجيد
منذ السبعينيات من القرن الماضي زحفت الرواية كفن، شيئا فشيئا لتحتل واجهة المشهد الأدبي. أذكر أنني كتبت يوما آنذاك أن الرواية سبعينية، وكنت أعلق على ما عشناه في الستينيات، وكيف قيل وتحقق ما قيل من أنها سنوات القصة القصيرة. كان ذلك صحيحا سواء مما كتبه الستينيون، أو من قبلهم مثل يوسف إدريس، الذي ظل يدهشنا بقصصه القصيرة، وهو من جيل أسبق، لكنه تجاوز الأجيال بكتاباته.
جاءت السبعينيات بتغيرات كبيرة في الحياة المصرية والعربية، فقد حدثت حرب أكتوبر/تشرين الأول وما بعدها في مصر من سياسية واجتماعية واقتصادية، فتحت الباب لخراب البلاد بما سمي الانفتاح، وبديمقراطية شكلية سمحت بظهور الأحزاب، لكن كما أكد السادات أن الديمقراطية لها أسنان، بمعنى أنه يعرف متى يوقفها، وفتح الباب للتيارات والحركات الإسلامية ، فتغير شكل المجتمع، أو بدأ يتغير إلى طريق ضال، ما جعل الباب ينفتح للسرد أكثر مما هو للإيجاز، فبدأت الرواية تحتل المشهد، وحدث الأمر نفسه في العالم العربي، فقد كانت مصر وقتها ملهمة رغم ما مرّ بها من كوارث.
أذكر يومها أن غضب عدد من كتاب الستينيات من كلامي، وعلى طريقتهم تصوروا أنني أنفيهم، رغم أن من بينهم من بدأ بكتابة الرواية في الستينيات نفسها، ومنها بدأت شهرته مثل صنع الله إبراهيم، الذي ظل مخلصا للرواية، وعبد الحكيم قاسم الذي كانت بدايته بروايته الفائقة الجمال «أيام الإنسان السبعة». لم يلتفت أحد إلى معنى كلامي عن تغير الحياة الاجتماعية، وما تستدعيه من تغير في طريق السرد.
وأذكر أنني في الثمانينيات كتبت مقالا، بعد أن صارت الرواية تحقق وجودا، في مجلة «الهلال» قلت فيه إن الرواية الآن هي ديوان العرب. كان الشعر يتراجع عن مقدمة المشهد إلا لأسماء كبيرة وكان شعراء السبعينيات في مصر يخوضون معركتهم مع الشعر السائد. لا أقصد شعر التفعيلة القديم فقط، لكن حتى الشعر الحر، وكان شعارهم الكبير هو أن يخرج الشعر من الشفاهية التي تجذب الجمهور إلى الصورة الشعرية مهما كانت غامضة، فليس عيبا أن يكون متلقي الشعر متأملا في ما يقرأ، وان ينفرد بالديوان بعيدا عن المحافل العامة. والحقيقة نجحوا في ذلك وقدموا لنا اسماء رائعة في مصر وغيرها أيضا، لكن الرواية ظلت تتقدم المشهد، ومع الوقت زادت في دول عربية كانت بعيدة إلى حد ما عنها، وبدون تمييز صار كتّاب الرواية الآن في مصر والدول العربية كثيرين جدا ويزدادون.
فالفن غواية والغواية يمكن أن تأخذ صاحبها أحيانا إلى قاع البحر، وما أكثر ما فعلت السيرينيات اليونانيات ذلك، بمن يسمعهم في السفن وهي تعبر البحار.
جاءت الجوائز العربية والمصرية للرواية أكثر منها لأي شيء آخر، وساهمت بدورها في تصدر الرواية المشهد. ليس لي مشكلة شخصية ولا أدبية في ذلك، لكن المشهد انفتح إلى درجة أن صرنا نقرأ اعلانات تقول كيف تكتب الرواية في أسبوع وكيف تنشرها. وانفتح المشهد إلى درجة أن البعض صار ينشر فصولا من رواية يكتبها على صفحة له في الفيسبوك يطلب رأي القراء ويقوم بالتعديل، فصارت الرواية صنعة. ولن أتحدث عن الورش التي شاعت لتعليم فن كتابة الرواية، فهذه لا تضر كثيرا لأن في الورشة بعض المحاضرات حول الكتابة وينصرف الجميع بعد ذلك، وكل يبحث عن طريقه. طبعا الجوائز المحتفية بالرواية فتحت الباب للشعراء والنقاد والصحافيين والمحامين والسياسيين، وكل الفئات أن تكتب الرواية. وليس لديّ اعتراض على هذا كله، فالفن غواية والغواية يمكن أن تأخذ صاحبها أحيانا إلى قاع البحر، وما أكثر ما فعلت السيرينيات اليونانيات ذلك، بمن يسمعهم في السفن وهي تعبر البحار. المهم أن يعرف من تأسره الغواية أن النهاية ليست دائما جميلة، فالرواية فن له تاريخ ومدارس، والكتابة ليست مجرد حكي، وفن الرواية لم يعد منفصلا عن الفنون الأخري، السينما والمسرح والموسيقى والفن التشكيلي إلخ. بلا شك يعرف كثير من المتحولين إليها ذلك، خاصة من الشعراء والنقاد، وقد حقق بعض الشعراء روايات مهمة، سواء فازت بجوائز، أم لم تفز، فهم قادمون من حقل الأدب.
ما جرى من تسليع لهذا الفن هو ما يزعجني، وقد أشرت إلى بعض ملامحه. فالكاتب والفنان في إبداعه يكون وحده داخل المعبد، لا يفتح الباب لأحد، وغالبا لا يشعر بأن في الدنيا حوله غير ما يبدعه، وحين ينتهي منه تأتي مرحلة التسليع، فهو ينشره إذا كان رواية أو ديوانا أو مجموعة قصصية أو لوحة تشكيلية. هنا يأتي القارئ أو المشاهد وهو حر في تلقيه، وعلى الكاتب أن لا يعلق على الآرء فلقد صار ما أنجزه سلعة الآن، ولم يعد مقدسا في معبد! التسليع هكذا يأتي بعد النشر وليس أثناء الكتابة. أذكر مرة من باب الضحك أني وأنا أكتب رواية «الإسكندرية في غيمة» قابلت في المقهى صديقا صدفة لم أقابله منذ سنوات، وأخذنا الحديث إلى أيام الجامعة في السبعينيات وسألني هل تذكر فلانة؟ لم يكن يعرف أني استلهم فلانة هذه في الرواية كما رأيتها في السبعينيات فائقة الجمال. طبعا تغير اسمها في الرواية وأضاف الخيال إلى الأحداث، لكن مجرد تذكري لوجهها المبهج، وكونها كانت بين الطلاب الشيوعيين المعادين لسياسة السادات صارت مصدر إلهامي لإحدى الشخصيات. قلت له طبعا لا أنساها، فقال لقد صارت عجوزا جدا. هنا كدت أسبه لكني تماسكت وأنا أقول في نفسي «حتبوظ الرواية يابن..»، ولم أكن أتحدث عن الرواية كعادتي ولا موضوعها فهذا أفعله دائما قبل النشر بأيام. دفعت له ثمن القهوة واعتذرت لانشغالي، وتركت المكان وأنا أحمد الله أني في الفصل الأخير في الرواية، الذي ليس لها فيه دور. طبعا أنا لست مقياسا لأحد لكن لا أظن أن مبدعا حقيقيا لا يعيش ما أعيشه مع الكتابة في معبده. التسليع الحادث الآن يجعل الباب مفتوحا لأي شخص، وما أكثر من يرون الآن أن الرواية هي الشهرة والجوائز وتساعدهم الميديا، فيتحدثون عما يكتبون ويطلبون رأي المتابعين وهم يكتبون. فضلا طبعا عن عدد قليل جدا الحمد لله يرى الرواية الآن قيمة لصاحبها، فلماذا لا يشتريها، حتى صرنا نعرف أن هناك من يستأجر من يكتبون له، والحمد لله ليسوا كثيرين، وحتى ظهر إعلان مرة في جريدة عربية لواحد مستعد أن يكتب الرواية لأي شخص نظير مبلغ من الريالات، أظنه كان يبدأ بعشرين ألف ريال. أخيرا بسبب هذا التسليع السائد الآن في تجلياته المختلفة ماهي الأفكار المجنونة التي جعلتها عنوانا للمقال؟ هي فكرة الاجتماع بعدد من النقاد والكتاب الأصدقاء في مكان جميل، والاتفاق على إطلاق صيحة زمن الشعر، أو زمن القصة القصيرة، ونتفق على أن نعمل عليها ونشيعها، ونؤكدها كل يوم لنرى ما هي مصداقية كتابة الرواية الآن. طبعا هذا لن يحدث ولا يمكن أن أفعله لكنني اقترحته على الفيسبوك مرتين متباعدتين فهل من مجيب حتى ننقذ الرواية من التسليع على الأقل، ونعيد إليها جلالها. أضحك وأنا أكتب هذا الكلام وأتخيل حاكما عربيا أصدر قرارا بمنع جوائز الرواية، وجعلها كلها للقصة القصيرة، وبعد أن يتحول الكثيرون يلغي قراره ويجعل الجوائز كلها للشعراء، ثم يلغي جميع الجوائز ويترك هو أيضا حكمه ويمضي. الرجاء أن لا يؤخذ الكلام على محمل الجد لكن دعوني أضحك فالمساخر تحيط بنا في كل شيء.
٭ روائي مصري


