المواضيع الأكثر قراءة
- "فنزويلا بعد مادورو".. سؤال السلطة ومصير الدولة
- مواجهات في الخليل واعتداءات للمستوطنين في سلفيت ورام الله
- نهج تشاركي لحماية الأسرة وتعزيز رفاهها
- وزارة الخارجية تؤكد أن جميع الأردنيين المقيمين والموجودين في فنزويلا بخير
- الأردن يرحب بدعوة رئيس المجلس القيادي اليمني لعقد مؤتمر شامل لبحث الحلول العادلة للقضية الجنوبية
- الأمم المتحدة تراجع عودة اللاجئين السوريين من الأردن 13
- تقدم درع الوطن وانسحاب الانتقالي.. ماذا نعرف عن آخر المستجدات في اليمن؟
- كلمة السرّ في الإعجاز القَطَري - | إبراهيم الابراهيم
- أورنج الأردن تطلق "دليل الشمول الرقمي" بلغة برايل لتعزيز تجربة الزبائن من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية
- وفاة رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب
الأنساق الثقافية في المدونة الشعرية «وأقبل التراب...» للشاعر عمر أبو الهيجاء
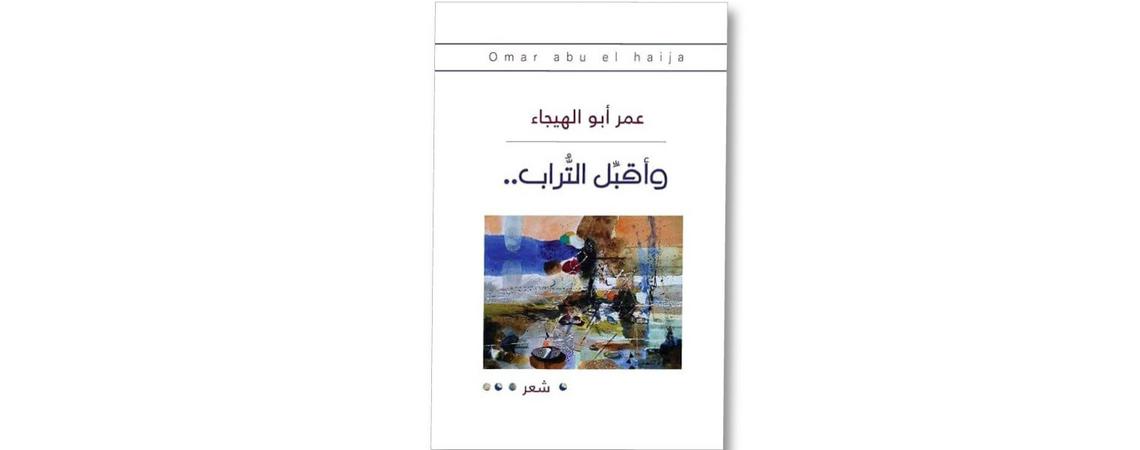
الدستور-د. عبدالرحيم مراشدة
ابتداء سألت نفسي: ما السبيل إلى قراءة هكذا نصوص، يتوافر فيها كم متراكم من المرجعيات والتوصيات التي تحيل إلى اقتطاعات مرجعية متنوعة، لهذه الأسباب، وربما لغيرها، اتجهت للنقد الثقافي الذي يمكن أن يسهم في تفكيك بعض الدلالات العميقة في النص، ولعل من المفيد قراءة مثل هذه النصوص من زاوية النقد الثقافي الذي ينطوي، قرائيا، على الأنساق الثقافية والمرجعيات العابرة لثلاثة أفكار هي: فكر منشئ النص، وفكر النص، وفكر القارئ، فالنص هنا يفرض قراءة في سؤال الوعي الثقافي، ذلك أنه ينهل من مرجعيات ومصادر وكينونات تتعالق مع الذاكرة الجمعية وما تختزنه عبر التراكمات المعرفية.
قبل الشروع في التطبيق على المدونة مدار البحث أوضح للمتلقي القراءة التي سأتبناها هنا تحت سقف النقد الثقافي، وبمثال من النصوص الشعرية القديمة، يقول جرير التميمي (ت 110هـ) «وإن التي يوم الحمامة قد صبا/ لها قلب تواب إلى الله ساجدِ/وتطــلب وداً منك لو تستفيــده/لكــان البيـــان أحب الفــوائد.»
فالحمامة التي يجري استجلابها هنا هي الحمامة التي ظهرت للقلب التواب وهي صفة لقلب داوود عليه السلام، لم تعد الحمامة الواقعية كما ترسخت في الذاكرة التقليدية، وإنما تم اختيارها من سياق معين له حزم دلالية تتفتح بالقراءة الواعية، فهي في النص عند جرير نتاج نسق ثقافي معين ارتبط بحادثة وخبر حدث للنبي داود عليه السلام، ورد في مزاميره وما تناقلته الأخبار، حيث يتمثل الشطان له في شكل حمامة ويكون نذير شر فانزاح رمز الحمامة عن السياق العام المعروف في، وهي تختلف عن حمامة نوح عليه السلام الواردة في قصة الطوفان حيث كانت بشرى بإمكانية الخروج للأرض وانتهاء الطوفان. لنعد إلى المدونة (وأقبل التراب ...) التي سنجد فيها انحرافات سياقية قصدية باتجاه الثقافة والانساق المعرفية الضاربة في التاريخ والحضارة منذ العنوان الحاضن للجملة: (واقبل التراب) فهي جاءت فعلية- حداثية – منقطعة عن سياق سابق، بدلالة الرابط واو العطف، وهنا يمكن القول بإمكانية التوقع على أنه سيفعل كذا وكذا أو فعل، ثم يأتي ليقبل التراب، فيبدو الكلام المنقطع والمعمى يحتاج لتكملة ويمكن صياغته ذهنيا بأن الشاعر أعد العدة وفكر في ذهنه، وهذا ما يكشفه السياق، ذلك انه سيضمر زيارة فلسطين وبعض المدن، وعندها سيقوم بتقبيل التراب، وكما نعلم أن عملية التقبيل تنطوي على حنين وشوق لعزيز. وقد بدأ الشاعر من لحظة الوصول لفلسطين في تسريد نصه الرحلي الشعري.
(لماذا الرحلة وما علاقتها بالانساق الثقافية؟)
لقد وردت الرحلة في الأدب بتنوعات مختلفة، ودار عليها كلام كثير، منها الرحلة الاستكشافية – الجغرافية، كما تعلمون كرحلة ابن بطوطة ورحلة كولومبوس، والرحلة الفلسفية كما نجد عند ابن شهيد والمعري في رسالة الغفران، ورحلة العطار في منطق الطير، وتم توظيف سياق وسرديات الرحلة في الأدب لا سيما الرواية، مثل مدونة الف ليلة وليلة، وفي رواية ابن فطومة لنجيب محفوظ، وغيرها كثير، لكن الرحلة في الشعر لا نجدها كثيرا، الا بشكل مقتضب، وغالبا ما تكون في لوحة من لوحات القصائد، كما ورد في متن بعض لوحات القصيدة الجاهلية، والمعلقات خير مثال على ذلك، أما في الشعر الحديث لم تصل إلى درجة تشكيل ظاهرة متكاملة إلا على وجه الندرة، وإن وردت في بعض القصائد تأتي عبر مشاهد لا تأخذ حيزاً كبيرا في النص ولا في المدونات الشعرية، لهذا يمكن القول أن شاعرنا يُحسب له استثمار الرحلة بشكل أكثر رحابة واتساعا، بحيث جعل المدونة الشعرية – الديوان – بكليته يقوم على مركزية هامة هي الرحلة.
لقد اختار الشاعر مجموعة من المدن لرحلته التي كان لها الأثر في ذهنية الإنسان العربي والمسلم، فإذا كان غسان كنفاني في ثقوب الخزان لا يقوم هو بالرحلة، فقد قام نيابة عنه الشخصيات التي استدعاها وابتكرها لروايته، وكان العبور المميت الذي نعلم، حيث أوردت الرحلة الغسانية – نسبة الى غسان كنفاني - إن جاز التعبير الى استظهار مأساوية الحدث العظيم من نتاج النكسة والنكبة، أما عمر الشاعر قام هو بالرحلة، جسدا وروحا وفكرا، وتحقق له ذلك عبر المعبر لفلسطين.
لم يقم الشاعر عمر أبو الهيجاء بسرد مباشر، ولا بقصة عابرة، وإنما قدم شعرية كثيفة رامزة تحيك نسيج نص رحلي شعري إبداعي تشبع بالمضامين الفنية والفكرية، ومن هنا كانت الانزياحات الأسلوبية ناجحة. فقد تكررت في القصيدة كثيرا كلمات مفتاحية ومركزية تشكل مفاصل قرائية أو قوى عمل لتفكيك النص بتعبير دريدا، وهي (المعبر، الأرض، التراب – طين الأم – إلى أن يصل للقول بجملة لها ما لها من ترهين الزمان والمكان عند نقطة حارقة تثير المشاعر والعواطف والذاكرة، عند قوله هنا فلسطين التي استثمرت كلازمة، بعد فراغ طويل وشَرطة، كما لو أن الشاعر يدعو المتلقي للتأمل والوقوف والتفكر عميقا، هذا الفراغ يضمر الحنين والغصة والشوق:»هنا فلسطين/رميت جسدي مفترشا أهداب/الأرض/كأني أرتب ولادة أخرى/ولادة طفل لم ير غير القانصين/وسماسرة الموت في جدول المعنى».
هذه اللوحة المشهدية تقدم اختزالا للمأساة التي حلت بفلسطين وشعبها، علما أن كلمة فلسطين تكررت عبر اللازمة فنيا لثلاث مرات، وقليلا ما تكررت في القصائد التالية، ولم تتكرر لفظا في المجموعة وهذا يتناسب وكثافة الشعرية والابتعاد عن المباشرة. ولو أردنا الإشارة مبدئيا إلى الأنساق الثقافية المتعالقة في النص والتي تستدعي القراءة عبر النقد الثقافي، لوجدنا: كلمة المعبر في السياق لم تعد معبرا عاديا للمرور، وقد انسلخت من المعطى التقليدي وأصبحت تشير إلى المتاريس والجنود والمعاناة والاحتلال عند الإنسان الفلسطيني، والمشرد الذي ذاق كثيرا من العذابات، وقد لا تشكل في ثقافة الاخر الا معنىَ بسيطا، وهذا يعني أن الكلمة هنا تستند إلى ثقافة شعب بعينه وأرض بعينها... والأرض التي تتهيأ لسرب العصافير، هي أرض دنسها الاحتلال وتتوق لسرب المهاجرين الذين تشبهوا بالعصافير المهاجرة.. اذا ليست العصافير لإثارة البعد الجمالي بقدر ما تشير إلى أبعاد سلبية مختلفة تماما تتناسب وخطاب النص، في هذه القصيدة نجد الكلمات التي تثير شهية الدلالة (كوفية التراب، وكعبة الروح، وسماسرة الموت إلى أن يصل لحكايات يسردها الأب عن البيوت والمنازل القديمة والنفي والمخيم والجرح والشهداء واليتامى... واستدعاء الغراب والخيول وأريحا أقدم مدينة في العالم) تبدو المدونة بهذا الاتجاه تحكي سيرة شعب عاش آلاما يعرفها الكون.
(البعد الحواري والبلفوني والأنساق الثقافية)
اللغة باتساعها وقدرتها على احتضان مجمل أفكار قادرة على أن تتشكل وفق رؤى من يستثمر عناصر هذه اللغة، ولنلفت الانتباه هنا إلى ما قيل حول هذه المسائل، لا سيما ما جاء في ما يعرف بالبعد البلوفوني، المبدأ الحواري عند باختين وغيره من جماعة حلقة براغ الذين أسهموا في دعم الدرس النقدي الحداثي، وأفاد من ذلك المبدعون في الأدب.
أقول ذلك لأن الحوارية في معظم قصائد هذا الديوان والبلوفونية تشكلان ملمحا لافتا ومهيمنات تحفر في أعماق بعض المرجعيات التي تأثر بها واستوعبها، وحاول توظيفها الشاعر، مع الخلفيات – النيات- التي يراها مناسبة لدعم خطابه الثقافي.
تتوزع الحوارية بين الحوار بضمير الأنا وحينا مع الذات – المنولوج الداخلي الفردي والجماعي، بمعنى نجده يتحدث بوصفه ساردا مع نفسه عن نفسه مع الكون والحياة مر، وأخرى بلسان الجماعة، كما في قصيدة المعبر يبدأ:»عند المعبر/أمر واقفا على الكلام/كانت الأرض مهيأة لسرب العصافير/في فسحة الشجر المنتصب/على الطرقات/مررنا باكين، التراب عطر نوافذ الروح/شمس المغيب تغرق فينا».
نلاحظ ابتداء السرد بضمير الأنا المفرد، لكن يظهر ما يشغل الذهنية والنية، والمفكر فيه، ويستند إلى قضية ليست له فقط، ولهذا نجد الضمير يتحول إلى الجماعة، فتحولت (أمر إلى نمر) وبين الصوتين تشع شعرية النص لتحيله عبر نسق الكلمات إلى القضية الفلسطينية، والمعاناة بشكل غير مباشر، وهذا من متطلبات الشعرية حيث تتعزز بالكثافة والصورة وبلاغة النص وفلسفته وهذا يتبدى من الكلمات (الشجر المنتصب) وهنا الشموخ رغم كل ما يحدث للأرض التي تبقى الشعوب واقفة في انتظار الخلاص.
أما الحوارية في قصيدة «نيابولس» فيتكئ الشاعر فيها على مسألتين: صوت الماضي الذي يترحل عبر ذاكرة الشاعر إلى الحاضر ليجري ترهين بعض الأزمنة والأحداث، عبر اللغة وهنا يمكن الإفادة نقديا من «نحو النص» فكان الاستخدام المهيمن لكلمة كان، وكنت، وقد وردت بهذه الصيغة، التي تبدو بسيطة لكنها انسلخت من المعطى التقليدي المباشر، وراحت تفتح شبابيك ونوافذ على ما كان من أحداث سياقات تقدم بأسلوب القص حيث يتداخل الشعر والقص . وتتكرر أيضا كان بصيغة أخرى حيث تأتي بأسلوب السؤال، الذي نطوي على قلق وتوتر ومحاولة لوم الذات، فنجد الصيغة السردية بشعريتها تأتي «كان لي، وكان عليّ» القول كان لي أي ليس الأمر الان بعد عبور فلسطين بيدي وإنما بيد الآخر – المحتل – ولهذا كان الإلحاح على عبور الوطن بأية طريقة.
«وكان لي/ أن دخلت نيابولس عاشقا/ أتقدم جبل النار/ أشم رائحة الصابون/ تقدمت/ وارتميت/ بين جبلين/ جرزيم وعيبال/ على مهل قرأت الكهوف والحجارة الملساء/ كنت حزينا كما تشتهي الأرض».
السياق الثقافي المرجعي هنا ينهل من ماض محدد ومن أشياء وتفاصيل لها أهمية خاصة في ذاكرة الإنسان، ولم تأتي السياقات بها عبثاً، وإنما لتثوير العاطفة والعشق للمكان وفضاءاته، لهذا يتم استحضار جبل النار – الشموخ والمقاومة والنضال الكامنة في التسمية، ثم نقرأ عن الجبلين وبينهما المدينة، ولم يأتي المرور عرضيا أبدا لدلالة الشوق الكامن في القلب والروح لهذه المدن التي تحتضن إرثا حضاريا ووجوديا، فكلمة قرأت الكهوف هنا لها معطى إيجابي بامتياز، ومضمخ بألم دفين، صحيح أن الصورة تأتي على سبيل التشبيه كما لو ان الكهف كتاب والحجارة أوراق ونصوص تقرأ، وهذا التفسير يبقى سطحياً، فالقراءة لمكان معين غير قراءة الآخر لذات المكان، القراءة هنا بهذا الصوت قراءة فاعلة ومنفعلة، لنضرب مثالا من الشعرر القديم، على هذه المسألة، حيث وقوف الشاعر الجاهلي على الأطلال التي تذكره بحبيبة ما غير وقف الراعي والمقيم في المكان: ولنا مثالا أكثر وضوحا، من الشاعر البحتري وهو يصف إيوان كسرى. عند قوله:»تصف العين أنهم جِد أحياء/ لهم بينهم إشارة خرس/ يغـتلي فيهــم ارتيابي حتى/ تتقراهــم يداي بلمــس».
في هذين البيتين نجد أن كلمة تتقرى والقراءة عند البحتري جاءت إيجابية مشبعة بلذة الوصف وبهجته، لأنه في لحظات فرح، ثم أنها بمعنى التفحص، أما شاعرنا فهو يتقرى ويتفحص المكان بنفسية أشبه ما تكون فلسفية وثائقية تاريخية مشبعة بالحزن والألم والحنين، ولهذا يود لو يمكث أكثر بالمكان (على مهلِ قرأت الكهوف) يعود لأصل الأشياء التي كانت له ولشعبه في الماضي، للتفاصيل التي تحتضن الحنين والحب والشوق، لميلاده وولادته وولادة الشعب الفلسطيني على أرضه.
يستمر أمر احتضان المكان وتفاصيله وعناقه حتى ينفجر السؤال القلق بصيغة ابتدائية قبل الشروع بالسؤال في القصيدة التي يذكر فيها: كان لي/ كما لو صوت لمرثية، فيصبح هو البحر، هذا الفضاء المنفتح في التيه والضياع والاتساع.. ويظهر صوت المنولوج الداخلي ( أراني محملا بموسيقى السفر) لكنها الموسيقى الأليمة كناية عن الهجرة والغربة والاغتراب، حتى الأرض تصبح يباباً أمامه، (أطوي مراحل يباب الأرض العالية، وينفلت السؤال القلق «أكان علي /» أفعل كذا وكذا .. فأي قصيدة ستكون مغمسة بالهجرة والدم والمعاناة والألم.. وأية زيارة ورحلة هذه؟؟ يصبح الكلام (منقوعاً بالدم) حتى يصل إلى صرخة مدوية فيقول: ( وأهتف باسم كنعان ) ويتضح استجلاب الحضارة الكنعانية والأصول التي سيتحدث عنها كثيرا في قصيدة أخرى هي (دارة العنب)، التي يستحضر بها المذبحة التي قام بها باروخ جولد شتاين في الحرم الإبراهيمي، وتركت جرحا في الذاكرة الإنسانية.
«أغذ الخطى إلى دارة العنب/أبدأ من خاصرة الجرح الخليلي/وأنا الولد الكنعاني/أضم الى الصدر خواطر الأهل/ في كتاب الطير/وأقول من يقرأ وجهي».
في النص السابق يستثمر المجالات المعرفية الساخنة، بوصفه مثالا وغيره كثير، في المدونة يمكن الوقوف على مفهوم دارة العنب الذي يحيل إلى الخليل بما لها من مرجعيات دينية وتاريخية وثقافية، لا سيما تلك التي تثير المسألة الوجودية للشعب العربي المسلم، حيث استدعى الشاعر ثيمة أساسية يعرفها المؤرخون وعلماء التراث والحفريات، ويعرفها أصحاب الديانات، جميعا، ألا وهي الوجود الأول للكنعانيين العرب وحضارتهم في أرض فلسطين بوصفهم الشعب الأول الذي تمدد على هذه الأرض المقدسة وانشأ حضارة راقية تعترف بها حضارات العالم، كل ذلك ينشأ من السياق (وأنا الولد الكنعاني أضم الى الصدر خواطر الأهل، في كتاب الطير وأقول من يقرأ وجهي)، اختيار الاسم الولد إشارة ذكية أن هذا الشعب منذ الوجود الأول والنشأة الأولى المتناسبة مع لفظة الولد الكنعاني سليل الكنعانيين.
يبقى عمر أبو الهيجاء بحق شاعر يعي منتجه النصي، ويستثمر من منابع وروافد عدة في سبيل انشاء استراتيجية لخطابه في محاولة للتجاوز والتخطي للسائد عبر التجريب، من حيث الكتابة العابرة للثقافة المحلية والعربية والإنسانية، وهذا يحسب له، وبظني ستبقى مثل هذه النصوص علامة فارقة على الشعرية المتحولة والمتجددة باستمرار، وتستدعي وتحفز المتلقين، لا سيما النقاد للنظر في مثل هذه النصوص.


