المواضيع الأكثر قراءة
- ما قصة الطيارين الذين يتم تجهيزهم في لبنان للتحرك ضد دمشق؟
- الصومال يرأس مجلس الأمن لأول مرة خلال 50 عاما
- حالة الطقس المتوقعة في الأردن خلال الأربعة أيام القادمة
- الأمن السوري يقبض على مجموعة من مليشيا (درع الساحل)
- الاحتلال الاسرائيلي يؤكد أنها ستطبق حظر أنشطة 37 منظمة إنسانية في قطاع غزة
- الأرصاد: أمطار متفاوتة في المملكة ودير علا تسجّل أعلى الهطولات
- مستقلة الإنتخاب: أحزاب أُوقف تمويلها وأخرى أُقيمت دعاوى لحلها
- أكاديميون: الجامعات مطالبة بتغيير برامجها لتحقيق التنمية المستدامة
- ممداني في حفل تنصيبه: للفلسطينيين مستقبل في نيويورك
- الوزير الأسبق صالح ارشيدات في ذمة الله
الرواية الجزائرية… من السياسة إلى الفن
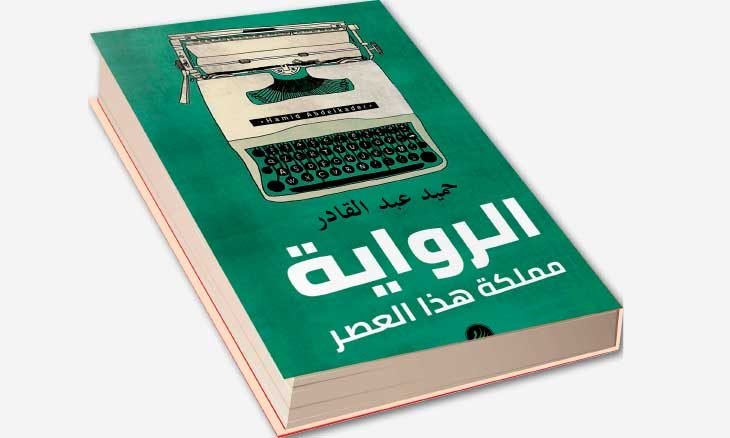
القدس العربي-سعيد خطيبي
كل رواية لا تنال نصيباً من النقد، ولا يلتفت إليها دارسون، فمصيرها النسيان، ستظل تراوح مكانها، ولن تصير نصاً جديراً بالاهتمام، كما لو أن النقد من ينفخ روحاً فيها، بالمقابل فإن النقد ليس «سيداً»، لم يشف من سقطاته، لم يتخفف من نرجسيته ومن خوفه في السير على أراضٍ جديدة، لذلك سيظل أشبه برجل مريض إذا لم يتحل بما يكفي من «جرأة».
وفي القرابة بين الرواية ونقد جريء تكتمل دائرة مهمة من دوائر الأدب، ذلك ما يُخبرنا به حميد عبد القادر، في كتابه «الرواية… مملكة هذا العصر» (دار ميم ـ 2019)، وإن تعددت اهتمامات هذا الكتاب، وطاف أصقاعاً يلتمس نوراً أو حيوات جديدة في الرواية العالمية، فقد كرس مقاربات مهمة في الرواية الجزائرية الناطقة بالعربية، التي لم يكفها أن تأخر ميلادها مقارنة بدول الجوار، بل إن أزمات حادة صادفتها في بداياتها، أهمها هاجس السياسة، فالجزائر بعيد الاستقلال كانت بلداً سياسياً بامتياز، لا يفلت فيها تعبير فني عن خدمة البروباغندا الرسمية، هيمن شبح الحاكم على مخيلة الكاتب، واستمر الحال كذلك طويلاً، حوالي عشرين سنة، لذلك لا نندهش من تغييب الرواية الجزائرية عن القارئ الأجنبي، فقد كانت حينذاك مولعة بتدوير محليتها، صابرة في خدمة القصر، ولم تتحرر من الأيديولوجيا سوى لاحقاً، وليس دفعة واحدة، بل على مراحل، فقد ضيع الروائيون الجزائريون كثيراً من الوقت، ولم يستفيقوا من الغيبوبة قصد خلق طفرة أدبية إلا بعدما شعروا بأن الماضي كان زائفاً في جزء كبير منه.
يبرر المؤلف عنوان الكتاب في المقدمة، ونقرأ: «الرواية اليوم بمثابة مملكة هذا العصر، وسيدة هذا العالم، من منطلق امتلاكها لسمة امبراطورية، وحيازتها على ميل لا ينضب نحو الانفتاح والتوسع، مثل البيئة الغربية، التي وُلدت وانتشرت فيها. فهي تعبر عن روح العصر الغربي (الرأسمالي)، وهو يكتسي روحاً توسعياً». لم تعد الرواية مجرد نص، بل حاملة قضايا المجتمع الذي خرجت منه، إنها واحدة من أدوات الهيمنة والتوسع، لذلك فإن عبد القادر يوحي للقارئ بألا يتعامل بحياد مع هذا الفن، لأنه مشبع بالانحياز، فقد سحقت الرواية كل ما يقف في طريقها، أحالت ضروباً أدبية أخرى منافسة لها إلى الظل، بل إنها تنوب أحياناً عن السياسة والتاريخ. لكنها لم تتخل عن ماهيتها، بوصفها نصاً إبداعياً، لا بيانا أو مانيفستو، كما شاعت في الجزائر بين سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، فإذا كانت أول رواية جزائرية، باللغة العربية، ظهرت عام 1971 «ريح الجنوب» لعبد الحميد بن هدوقة، فقد شهدت حينها ميلاداً عسيراً، ميلاد نص وليس فنا، أو عائلة أدبية، خرج إلى النور كي يسير خلف قاطرة السياسة لا إلى جانبها، تابعاً لا نداً لها، ويورد المؤلف مقولة للروائي جيلالي خلاص: «الرواية الجزائرية نزلت متأخرة إلى عالم الإنسان وهمومه». والأصح أنها اهتمت فقط بالإنسان «الأعلى»، الحامل لعصا الطاعة، إن سايرته في نزواته وفي أحلامه الطوباوية، انشغلت بترديد فضائل الاشتراكية، وفي السباحة مع التيار، وافتقرت إلى رؤية جمالية مثلما افتقرت إلى روح المقاومة وفي الالتفات إلى الطبقات الدنيا.
يحيل حميد عبد القادر علة «تطرف» الرواية الجزائرية، في بداياتها، إلى السياسة على حساب الفن، إلى تأثرها بمنظومة التفكير الفرانكفونية، ما أنتج كتاباً «متأثرين بالتقاليد والنزعات الأيديولوجية أكثر من تأثرهم بالإنسان وبما هو إنساني»، وهو حكم يحتاج إلى توسع وإلى طرح أمثلة واسعة، لأن الروائي الجزائري تأثراً أيضاً بالمنظومة العربية، وبالتراث العربي، كما أنه لم يتخل عن تنشئته وبيئته وثقافاته المحلية، وإذا افترضنا جدلاً أن مقولة المؤلف صائبة، فكيف نفسر أن كتاباً جزائريين، ناطقين بالفرنسية، وهم أكثر قرباً للفضاء الفرانكفوني، مالوا إلى الإنسان منذ نصوصهم الأولى، مثل مولود فرعون؟
يُضاف إلى مسألة الانحياز وأدلجة النص، عامل آخر، لعب دوراً حاسماً في تعطيل انبعاث الرواية الجزائرية، هو الرقابة بفرعيها: رقابة ذاتية ورقابة مؤسساتية.
إن ما ورد في «الرواية… مملكة هذا العصر» يؤسس للأسئلة الأساسية في الرواية الجزائرية، التي غضضنا الطرف عنها، وانصرفنا إلى أسئلة هامشية، وبغض النظر عن صواب ما يذهب إليه المؤلف من عدمه، فإنه يستفز الباحثين قصد الإدلاء برأيهم في هذا الموضوع، وتعليل الميلاد العسير لرواية جزائرية ناطقة بالعربية، في بلد لم تفتر فيه الرواية بلغات أخرى!
يُضاف إلى مسألة الانحياز وأدلجة النص، عامل آخر، لعب دوراً حاسماً في تعطيل انبعاث الرواية الجزائرية، هو الرقابة بفرعيها: رقابة ذاتية ورقابة مؤسساتية، ويكتب عبد القادر: «تناولت الرواية الجزائرية منذ الاستقلال مسألة حرب التحرير، لكنها أحجمت عن قول أشياء اندرجت ضمن خانة المسكوت عنه. وسارت على درب الخطاب الرسمي»، ويُرفق ـ لاحقاً ـ مثالاً في رواية «اللاز» للطاهر وطار، التي كتبت «من منطلق نضالي». كادت الرواية في الجزائر أن تغرق في حكايات مكررة من حرب التحرير، حتى ظن القارئ أنها لن تخرج منها، لكنها لم تفعل ذلك عن قناعة، بل إرضاءً لموضة وكسباً لود السلطة، وتحول الكتّاب من روائيين إلى مؤرخين، يعيدون نثر ما جاء في كتب التاريخ، ويعلق المؤلف على هذه النقطة: «المؤرخ يتعامل مع الفاعلين كأنهم أبطال، بينما الروائي ينزع عنهم صفة البطولة»، وهو ما لم يتحقق في الأزمنة الأولى للرواية الجزائرية، وتوجب أن ننتظر سقوط جدار برلين على الهواء، وأن نشاهد الاتحاد السوفييتي يتفكك كي نستفيق من غفوتنا، وتدخل الجزائر عشرية الموت والدم، كي ينبت جيل جديد، تعامل مع تلك اللحظة التراجيدية أدبياً، لكن سرعان ما اصطدم بجيل الأيديولوجيا، الذي يحن إلى سنوات الاشتراكية، ووصفوا كتابات أولئك الشباب في التسعينيات ﺑ «الأدب الاستعجالي»، وهي عبارة تخفي رأياً مفاده أن ما يكتبونه ليس أدباً، بل شهادات، وضعوا روايات كثيرة في سلة واحدة، وحثوا الناس على نسيانها، وأصحاب تلك العبارة «هم كتاب لم يتخذوا موقفاً صريحاً من عشرية التسعينيات»، على حد قول الأكاديمي والروائي محمد ساري.
مع بداية الألفية الجديدة، صدرت أولى أعمال جيل آخر مختلف، مع أن المؤلف يحصر جل أعمالهم فيما سماه «روايات البوح»، روايات ذاتية «للتعبير عن هواجسهم ومآسيهم»، مع ذلك فقد طرأت استثناءات أعادت الروح للرواية الجزائرية، ووضعتها على خط الفن بدل السياسة، وخلصتها خصوصاً من الرقابة ومن الصدامات ومن حرب الأجيال، التي غاصت فيها الرواية الجزائرية طويلاً.
في «الرواية… مملكة هذا العصر»، يورد حميد عبد القادر (1967) بانوراما تاريخية للرواية الجزائرية، تشمل حوالي أربعة عقود من تاريخها، مع أنه اعتمد على مدونة ضيقة، وسقطت من تحليلاته أسماء مهمة، ويحاول ربط تلك الرواية بسياقات عالمية، ويطرح في الكتاب ذاته فصولاً عن روايات من أوروبا وأمريكا، كي يُنبه القارئ إلى ما يحصل خلف الحدود، يطرح أسئلة أكثر مما يعرض إجابات، ومن المهم العودة إليها ومناقشتها، بغض النظر عن اتفاقنا مع المؤلف أو معارضتنا له.
كاتب من الجزائر


