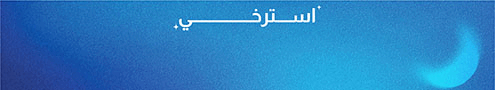الراي - بحكم موقعها الجغرافي كان على الأردن أن تتعايش مع فكرة التنوع الثقافي وتعدد المؤثرات الحضارية التي ترفد الثقافات المحلية، وتعطيها حيوية وتجددا يجعلها تكتسب العديد من القيم الإيجابية في بنائها الاجتماعي، فالتنوع الثقافي عادة ما يعلي من قيمة الظواهر الإيجابية لدى أي من أطراف التنوع، بحيث تقوم الثقافات المتفاعلة في بقعة معينة من الأرض، أو في داخل مجتمع محدد، بعملية من الانتخاب الاجتماعي لمجموعة القيم التي تنعكس في المكون الكلي لهوية المجتمع، صحيح أيضا أن بعضا من القيم السلبية في كل مكون تطرح نفسها لتصبح في بعض الأحيان أحد مكونات الهوية الجمعية، ولكن ذلك لا يمكن مقارنته بالتنوع الإيجابي في النهاية، ولا يمكن أن يقاس ذلك على فترات قصيرة تقاس بعقدين أو ثلاثة من الزمن، فعملية التفاعل الثقافي تحتاج فترات زمنية أطول كثيرا لتتضح في البنية الاجتماعية النهائية، وتفرض ذاتها، وهي في الغالب تمر بمراحل من الجزر والمد في حضورها الاجتماعي.
ينتمي الأردن بحكم موقعه إلى تركيبة ثقافية متنوعة، فهو يعتبر جزءا أصيلا من ثقافة الشام، حيث يعتبر الخط الأخضر في الأردن هو الحد الجنوبي لإقليم الشام، أو سوريا التاريخية، كما أن الأردن يعتبر جزءا من ثقافة الجزيرة العربية، وهو المنفذ الطبيعي لعبور الثقافة العربية إلى المناطق التي حكمت من قبل الإمبراطورية الرومانية في سورية الكبرى وشمال افريقيا، كما أن الأردن يعتبر أحد روافد طريق الحرير الذي أخذ يمتد من أوروبا إلى آسيا ليشكل أكبر حزام تجاري تاريخي، لم تكن تنتقل عبره البضائع والأموال، وإنما أيضا كانت اللغات والأفكار والمعتقدات تعبره بنفس الطريقة، فلم يكن الأردن مجرد أرضا منعزلة وبعيدة تطمح لأن تحافظ على سكينتها وهدوئها، وإنما كانت دائما جزءا من تفاعلات عالمية واسعة ومتعددة، فالأردن لم يكن أحادي الثقافة ولم يكن محكوما بالخوف والتهيب من الآخر، وكان الانفتاح وقبول الآخر هو الواقع السائد، ويمكن أن تستثنى بعض التجارب، على الرغم من أهميتها، مثل تجربة الأنباط في البتراء، والتي أتت كردة فعل لتوتر العالم القديم حول الأردن ودخوله في صراعات كبيرة، فموقعها المتطرف في عزلته كان لغرض حماية ثرواتها وثقافتها، فلم تكن عزلة قائمة على نبذ الآخر أو عدم الاعتراف به، ولا يمكن إهمال انتماء الأردن إلى حزام ثقافات البحر المتوسط، فهو كان جزءا مهما في الإمبراطورية الرومانية التي اعتبرت المتوسط بحرا رومانيا كاملا، وكان الأردن خط الدفاع الرئيسي عن الممتلكات الرومانية من الهجمات الفارسية التي تندفع من فارس ووسط آسيا.
هذه العوامل لم تذكر في كتاب عن التنوع الثقافي في الأردن قام بتحريره الشاعر حكمت النوايسة، وأتى الكتاب ليركز على واقع التنوع الثقافي في الأردن الحديث، والمكونات الثقافية المختلفة التي حملها المجتمع الأردني المعاصر بما اشتمله على تنويعات ثقافية متعددة كانت تتوزع عرقيا بين العرب بصورة أساسية، مع التقدير لثراء التجارب القوقازية والكردية والأرمينية في الأردن، وكذلك التنوع بين الثقافة الإسلامية حيث كان الأردن أول محطة لخروج الإسلام من الجزيرة العربية، وبين الثقافة المسيحية التي يعتبر الأردن جزءا من جغرافيتها التاريخية المقدسة، وفي الأردن تقع أقدم الكنائس في العالم بأسره في قرية رحاب بمحافظة المفرق، ويشتمل الكتاب على دراسة مهمة للزميل مفلح العدوان أتت بعنوان «التنوع الثقافي والنسيج الاجتماعي في الأردن»، ألقى العدوان الضوء من خلالها على أهم مكونات المجتمع الأردني الثقافية، وعرض لهذه المكونات وتاريخ اندماجها في المجتمع الأردني، والصفات التي حملها كل مكون في ثقافته الخاصة، والأثر الذي أضافه على الثقافة الأردنية بشكل عام، ولم يتناول العدوان فقط المكونات الرئيسية واسهاماتها الثقافية في الأردن، وإنما أيضا تناول بعض المكونات الصغيرة التي تدلل في تواجدها وتفاعلها على تعمق فكرة التسامح والانفتاح الثقافي في الأردن، ومن هذه المكونات أبناء بخارى وأعضاء الطائفة البهائية، وهو ما يحسب للعدوان كباحث أثبت جديته وحياديته في العمل في مجالات الدراسات الاجتماعية أو بالمعنى الأدق، الأنثروبولوجية.
يشتمل الكتاب أيضا على دراسات عن الجمعيات والهيئات الثقافية في الأردن، والإعلام وتنوع أشكال التعبير الثقافي، ودراسة حول الفعاليات الثقافية من خلال الإعلام المقروء، وتشتمل على عرض لمجموعة من الأنشطة الثقافية جمعها الزميل أحمد الطراونة، وتدلل هذه المجموعة من الأنشطة على توسع الاهتمام الأردني بالانفتاح الثقافي والإطلال على ثقافات الآخرين، وإن كانت تلقي بالأسئلة حول الإعلام الثقافي نفسه، وقدرته على متابعة هذه الأنشطة خارج الصورة التقليدية التي بقيت تنحصر في الصفحات المتخصصة التي تكتب بلغة تهم المختصين بالشأن الثقافي، ولا تلعب دورا في اجتذاب جمهور جديد للأنشطة الثقافية، وهو ما يؤكد على ضرورة أن تتوسع نشاطات الإعلام الثقافي وأن تطور أدواتها خاصة في ظل وجود المواقع الإلكترونية للصحف والتي يمكن أن تدعم التغطيات للأنشطة الثقافية بحضور الصوت والصورة في هذه العروض، ونقل أجواء الحدث الثقافي بدلا من الاعتماد على وصف الأنشطة.
تبقى ملاحظة مهمة، هو أن الموضوع يحتاج إلى أكثر من كتاب، وإلى التوسع كثيرا في الجوانب التي تتناولها قضية التنوع، ويحسب للنوايسة مبادرته بتحرير هذه المساهمة المهمة، ويجب أن يشكل ذلك تشجيعا للمثقفين للعمل على استكمال جوانب أخرى في مسألة التنوع الثقافي، ويجب على المؤسسات الثقافية أن تدعم ليس بطباعة الكتاب والمنجز النهائي، ولكن في تمويل الدراسات التي تحتاج إلى التوسع وتكتسب أهمية بالنسبة لتوثيق تاريخ وواقع الثقافة الأردنية.
العرب والغصن الذهبي
عادة ما يهمل قراء الكتب المترجمة التعرض لقراءة مقدمة المترجم، ولكنها تصبح ضرورية في حالة كتاب العرب والغصن الذهبي، لسببين، الأول، أن المترجم في هذه الحالة هو الناقد العراقي المعروف سعيد الغانمي، وهو بجانب جديته في العمل الفكري والنقدي، مترجم أثرى المكتبة العربية بمجموعة من الكتب المهمة، مثل، اللغة والأسطورة للفيلسوف أرنست كاسيرر، والسيمياء والتأويل لروبرت شولتز، أما السبب الثاني، فيتعلق بموضوع الكتاب نفسه، فالكتاب يذهب إلى الأسطورة العربية القديمة، وتحديدا الأسطورة المتعلقة بقبيلة ثمود التي تنتمي إلى العرب البائدة، وهذه القبيلة ورد ذكرها في القرآن الكريم في أكثر من موضع، ويتناول الأسطورة بالبحث والتفكيك أكاديمي أمريكي يحاول أن يقتحم مجالا صعبا لما يتصف به من شح في الروايات والأخبار، كما أن جانبا من المدونات العربية حول ثمود وغيرها من القبائل العربية القديمة كانت مجرد قصص غير مستندة لأصول موثوقة، وزخرت هذه القصص بالعديد من المبالغات والتصورات الخاطئة.
محاولة المؤلف ياروسلاف ستيتكيفيتش لربط الأسطورة العربية بجذور أخرى اغريقية ولاتينية قديمة، ومحاولة استقصاء بعض المدونات العربية التي تناولت أحداثا وقعت قبل وأثناء غزوة تبوك على مقربة من مدائن صالح، هي محاولة ثرية ومهمة، ولكنها تتصف ببعض عيوب الدراسات المقارنة في هذا السياق، وهو الذي يفترض ولو ضمنيا وجود عمليات نقل مباشرة عن مصدر واحد وأساسي ومستقل، كأن يكون الأسطورة الفارسية أو الاغريقية تحديدا، ولكن ذلك ليس لازما من الناحية المنطقية بالضرورة، فالذهنية الإنسانية القديمة خرجت من جذور مشتركة وحملت تفسيرات متشابهة بقيت تتوالد في أكثر صورة وعبر أجيال متتابعة في حضارات مختلفة، وبالتالي لا يتوجب أن تحدث عملية النقل، فعبادة المظاهر الطبيعية كانت موجودة في مجتمعات غير متواصلة ولا تتصف بالاحتكاك أو القرب من بعضها، لأن العقل الإنساني وفق معطياته كان مستعدا لقبول بعض الافتراضات وفق ما لديه من مدركات بسيطة وساذجة.
الكتاب يقدم محاولة متماسكة لترميم الأسطورة العربية القديمة، وهو الأمر الذي يحتاج إلى منهجية في التعامل مع مواد معرفية عديدة ومختلفة وهو الأمر الذي يتطلب تنظيما بحثيا ومنهجيا بالغا، وإن تكن الدراسات الغربية عادة ما تهمل الإطلاع على الموروثات الشفهية التي ما زالت تروى حول أساطير قديمة، وهو الأمر الذي لم تهتم الأوساط الأكاديمية العربية بتدوينه وتوثيقه.
معجم التنوير
الباب المفتوح
Open Door Policy
في جذورها تعني مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأمريكية في نهاية القرن التاسع عشر من أجل المزيد من المشاركة في الأحداث العالمية، خاصة مع وجود تفاهمات بين اليابان والدول الأوروبية لتقاسم مناطق النفوذ في الصين، تجاهلت الولايات المتحدة ولم تضعها في حسابات السيطرة على التجارة الصينية، وتوسعت هذه السياسة لتضم مطالب أمريكية متزايدة في مختلف الاتفاقيات العالمية حول تنظيم التجارة، وتعني الباب المفتوح تحديدا حرية التجارة في الصين، وكانت أول المطالبات الأمريكية بذلك سنة 1898، وتبعتها مطالبات أخرى تتعلق بكسر الاحتكار البريطاني لعقود التنقيب عن النفط في منطقة الخليج العربي ابتداء من عقد العشرينيات في القرن العشرين، وعلى الرغم مما يبدو للوهلة الأولى من معنى ايجابي لسياسة الباب المفتوح، إلا أنها تحمل معنى سلبي واستعماري، حيث أنه يطالب بفتح أبواب الدول المستعمرة أو الضعيفة، أمام القوى العالمية للتنافس بينها على أسس عادلة وفرص متساوية على استغلال ثروات الدول الأخرى، بينما لا يعني إطلاقا أن تفتح الولايات المتحدة أبوابها أمام بضائع الدول الأخرى، أو تتخذ مواقف سياسية بناء على علاقاتها مع هذه الدول، فالمواقف السياسية الأمريكية التي اتخذت ضمن سياسة الباب المفتوح عبرت أولا وأخيرا عن المصالح الأمريكية الخاصة.
بادر ماينهوف
Baader-Meinhof
الاسم الشائع لمنظمة عصبة الجيش الأحمر الألمانية وهي منظمة يسارية متطرفة اتخذت منهجية العمل المسلح لمقاومة الإمبريالية والرأسمالية الأمريكية والألمانية على الأراض الألمانية وفي مواقع أخرى من العالم، وتأسست هذه العصبة التي حملت الفكر الماركسي – اللينيني سنة 1970، واستثمرت الاحتجاجات الطلابية (1965 – 1968) على الأوضاع السياسية في ألمانيا الغربية في حقبة الستينيات، حيث كان القسم الغربي من ألمانيا يلعب دورا مهما في السياسة الأمريكية تجاه الاتحاد السوفييتي أثناء الحرب الباردة، وقامت المنظمة بالعديد من العمليات الإرهابية التي بنت سمعتها في ألمانيا وغيرها من دول العالم، ويعود الاسم المختصر إلى اثنين من مؤسسي العصبة وهما أندرياس بادر (1943 – 1977) الذي قام بتنفيذ العديد من العمليات وانتحر أثناء سجنه، وأوليرك ماينهوف (1934 – 1972) الصحفية التي وجدت منتحرة قبل محاكمتها على عمليات ارهابية قامت بها العصبة.
كانت آخر العمليات التي نفذتها العصبة سنة 1993، وكانت نهايتها بفعل الأمر الواقع نتيجة نجاح السياسات الأمنية التي اتبعت من قبل الحكومة الألمانية، والآثار التي ترتبت على انهيار الاتحاد السوفييتي وما ترتب عليه من واقع جديد في ألمانيا في مرحلة ما بعد انهيار سور برلين.
بالون اختبار
Trial Balloon
مصطلح سياسي إعلامي يعني تسريب أخبار أو اشاعات حول قرار يوشك أن يتخذ على مستوى الحكومة أو الدولة لمعرفة ردود الفعل التي يمكن أن يتخذها المواطنون في حالة كان قرارا محليا، أو الأطراف الدولية الأخرى في حالة كان موقفا دوليا، وتقييم ذلك، ويمكن أن يؤدي تقييم النتائج لمتابعة القرار وتفعيله أو العدول عنه، أو تعديل بعض الأمور فيه، أو تأجيله لوقت آخر، ولا يعني بالون الاختبار أن الخبر الذي يمثل موضوعا لتقييم رد الفعل صحيح أو مغلوط، فمصداقية الخبر ليست ذات أهمية بقدر التوقيت والطريقة التي يصدر بها الخبر.
كما يمكن أن يكون بالون الاختبار عبارة عن إجراء ضمن حزمة اجراءات أخرى تتخذها الحكومة على المستوى المحلي، كأن ترفع سعر بعض السلع كمقدمة لرفع جميع السلع لاحقا حسب ردود الفعل المحلية، أو اجراءات تتخذها الدولة على المستوى الإقليمي أو الدولي، لمعرفة إذا ما كانت ستمضي قدما في تنفيذ بقية الإجراءات أم أنها ستتراجع أو ستكتفي بالخطوة التي قطعتها والتي تعتبر بالون اختبار، وعادة ما تكون بالونات الاختبار في العلاقات الدولية مرتبطة بالصراع بين بلدين، كأن تقوم واحدة من الدول باشتباك محدود مع دولة أخرى، لتقييم ردود أفعال حلفاء الدولة المستهدفة، وفي حال كانت الردود قوية وحاسمة، يتم التراجع عن تطوير الاشتباك، بينما يتم تطوير الهجوم في حالة كانت ردود الفعل متراخية.
باندونغ (مؤتمر)
Conference of Bandung
يعتبر المؤتمر التأسيسي لحركة عدم الانحياز وعقد المؤتمر في مدينة باندونغ الإندونيسية بحضور ممثلي 29 دولة، وأكد المؤتمرون وعلى رأسهم الرئيس الأندونيسي أحمد سوكارنو والمصري جمال عبد الناصر واليوغسلافي جوزيف تيتو والهندي جواهر لال نهرو مجموعة من المبادئ تمثلت في احترام حقوق الإنسان، وسيادة جميع الدول المستقلة حديثا ورفض التدخل في شؤونها، وتسوية المنازعات سلميا وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، وكانت الدول المشتركة في المؤتمر تسعى لأن تجد لنفسها مكانا خارج الاستقطاب الذي جرى بين المعسكرين الغربي المتمثل بالولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا الغربية واليابان، وبين المعسكر الشرقي الذي مثله الاتحاد السوفييتي ودول أوروبا الشرقية وبعض الدول الآسيوية، وكانت العديد من الدول المشتركة في المؤتمر تعاني من محاولات الاستقطاب لأحد المحورين المسيطرين على العالم في تلك الحقبة.
البراجماتية Pragmatism
تيار فلسفي نشأ في الولايات المتحدة الأمريكية في القرن التاسع عشر، يصرف النظر عن البحث في الأسباب وجواهر الأمور والأشياء، ويركز على النتائج التي تترتب عليها، وأثرها على حياة الإنسان ومصالحه، فيعتبر الأمور الخيرة الجيدة التي تحقق المصلحة الإنسانية، التي تتمثل بدورها في أعلى قدر ممكن من الإشباع المادي والنفسي، بينما الأمور السيئة، هي التي تضر بمصالح الإنساني وتسبب له التعاسة، وبذلك لا يمكن لشيء أن يكتسب قيمة في حد ذاته، وإنما تكون قيمته بما يفيد به الإنسان أو يضره، وحتى الدين فإن البرجماتية تنظر له موقفا محايدا، ويكون مرغوبا فقط لإشباعه بعض الحاجات النفسية لدى الإنسان ليس أكثر، بمعنى أكثر تحديدا أن البراجماتية تمثل مرادفا للنفعية، ويلاحظ أن البرغماتية التي تأسست في أعمال الفيلسوفين الأمريكيين تشارلز ساندر بيرس (1839 – 1914 ) ووليم جيمس (1842 – 1910) تتناسب مع البيئة الأمريكية التي نشأت فيها، فهي تركز على الجانب العملي، كما أنها غير مثقلة بتراث حضاري عريق يحمل منظومات دينية وفكرية متنوعة ومتعددة، والحياة الأمريكية بشكل عام تدفع للتفكير في تعظيم الربح حيث كانت الجغرافية الأمريكية تغري المهاجرين الأوائل على استثمار جميع الفرص المتاحة دون وجود وقت للتفكير في الجوانب الروحية لهذه الحياة المرهقة.
من الناحية المعرفية فإن البراجماتية تربط بين ما هو حقيقي بما هو مفيد، فالتفكير في الأمور الأخرى الغيبية مثلا، ليس من الحقيقة في شيء، أو ليس من مجالات البحث عن الحقيقة، وليس ضروريا معرفته، لأنه لا يؤدي إلى فائدة عملية، ومن أهم فلاسفة البراجماتية جون ديوي الذي أسس للفلسفة الأدواتية التي تعتبر أحد فروع البرجماتية، وتقول بأن العقل ليس أداة للمعرفة، وإنما هو أداة لتطوير الحياة، فالعقل هو أداة الإنسان في رحلته على الأرض من أجل تحقيق مصالحه، وليس من الضروري أن يستهلك الإنسان عقله في البحث عما هو وراء الطبيعة التي أمامه، والتي تمثل واقعه الوحيد، أو على الأقل، الواقع الوحيد الجدير بالاهتمام والبحث.
في السياسة يجري الخلط بين البرجماتية والميكيافيلية، ولكن البرجماتية لا تسعى لتعزيز الجانب اللا أخلاقي لمصلحة السلطة، ولكنها لا تمانع في أن يتم ذلك على مستوى المجتمع، فالأخلاق يمكن أن تتطور من أجل تحقيق مصالح أكثر للإنسان بشكل عام، كما أن البرجماتية لا تعني الانتهازية، حيث أنها لا تفترض أن الإنسان يمكن أن يغير مواقفه لمصالح شخصية محدودة ومكاسب مؤقتة، وبغض النظر عن مصالح الآخرين والمنفعة التي تعود عليهم، إنما تغيير المواقف يكون مبنيا على بما فيه النفع العام والخاص الذي لا يتعارض مع المنافع الخاصة بالآخرين.
بيكاسو وستاربكس
يعتبر بعض المتابعين مشهد الطوابير التي اصطفت أمام محلات ماكدونالدز الشهيرة في العاصمة الروسية موسكو لشراء شطائر البرغر الأمريكية بمثابة اللحظة الحقيقية لإنهيار الاتحاد السوفييتي بكل ما مثله من قيم وأفكار طيلة عقود من عمر القرن العشرين، وإيذانا بتدشين عصر العولمة الذي تسيطر الشركات العابرة للقارات والثقافات، وماكدونالدز فوق أنها تمثل علامة تجارية عالمية وناجحة، تمثل جانبا من نمط الحياة الأمريكية الذي يقبل التصدير إلى مختلف أنحاء العالم، فهذه المطاعم خلافا للعديد من سلاسل المطاعم الأمريكية تقدم منتجا بأسعار وأحجام معقولة ومتعارف عليها، ولا تنافس في مجال الكبير الجميل الذي يفضله الأمريكيون وخاصة في الولايات الجنوبية، وكذلك، يمكن أن تعتبر سلسلة المقاهي المعروفة ستاربكس، فهي علامة تجارية مرموقة، تقدم منتجات عالية الجودة، وبجانب ذلك، يستدعي تواجدها في أي مدينة حول العالم جدلا ثقافيا سياسيا موسعا، تشتبك فيه بعض النخب، حيث يشيع أنها تتخذ مواقف سياسية متحيزة، ولكن ذلك ليس صحيحا، فببساطة تركز ستاربكس على منتجاتها وأرباحها، وهي بذلك تعبر عن ذهنية الليبرالية الاقتصادية المعولمة.
المؤلف الإماراتي ياسر سعيد حارب يلتقط مفارقات أخرى في عالم ستاربكس التي حولت احتساء القهوة من مجرد قرار روتيني وعفوي، إلى عملية معقدة تعطي عملاءها الفرصة لممارسة طيف واسع من الخيارات، وفي نقد مبطن يأخذ حارب على الزبائن النمطيين تمسكهم بالجانب الشكلي من الثقافة الغربية، دون إدراك لجوانب أخرى يستدعي الاندماج في نمط الحياة الغربية العمل بها، مثل تقدير الوقت والالتزام بالإنجاز، ويمضي نقد حارب المبطن في هذا الكتاب الذي أتى بلغة سهلة وممتعة وبعيدة عن التفذلك أو التشتيت لمجموعة من ظواهر المجتمعات العربية الحديثة، ويدعو حارب إلى ممارسة الإبداع في مختلف المجالات دون خوف أو وجل أو تردد يقوم على أسباب اجتماعية واهية، فالتقدم لا يتحقق إلا من خلال الاختلاف عن النمط السائد، وتقديم الجديد، وهو ما يستتبع أن يقدم المبدعون الثمن، ولا يتدخل حارب في إطلاق أحكام على القضايا الثقافية، وإنما يناقشها من مختلف الوجوه للخروج بتركيبة أو توليفة تتناسب كسر السائد الذي أخذ له نموذجا في ستاربكس، وفي الفنان الأسباني بابلو بيكاسو، الذي أخذ يبحث عن شخصيته فوجدها في إعادة ترتيب العالم بنظامه وفوضاه على طريقته الخاصة.